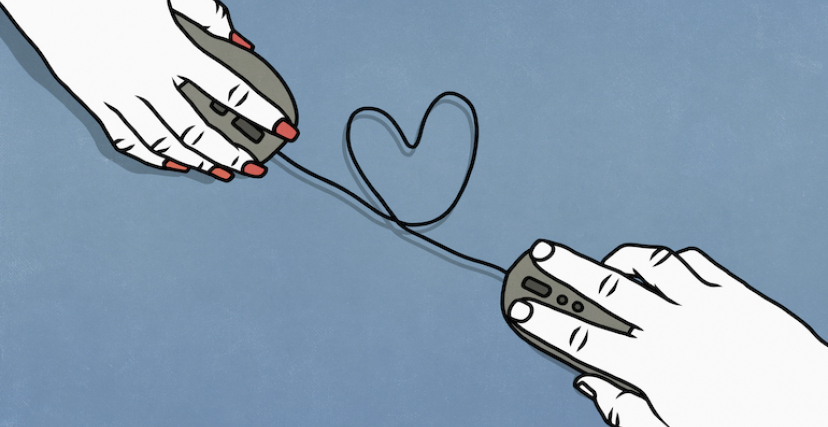فتاة عشرينية تبكي أمامي بحرقة، صامة أذنيها عن عباراتي المواسية الخائبة. تقول إن حلمها قد تحطم وعالمها انهار تمامًا، وإن حياتها صارت، منذ الآن، بلا أي معنى. ووسط النشيج كانت ترثي حبها الذي انتهى للتو، وتشجب بعبارات لينة حبيبها الذي أنهى، بلا رحمة، قصة الحب العظيمة ورحل إلى الأبد.
لقد اعتدنا على الكتاب الالكتروني بديلًا عن الورقي، فهل نستطيع اعتياد الحب الافتراضي بديلًا عن الحب الواقعي؟
وأنا في مأزق، فقد كنت ذلك الخمسيني الذي ورطته المصادفة في أن يغدو مستشارًا عاطفيًا فاشلًا لزميلة العمل الشابة هذه. كنت بلا شك أعرف شيئًا عن الحب وأشياء عن قلب المرأة وأشياء أكثر عن نذالات الرجل، وأحفظ بضع جمل ذهبية تسعفني في تقديم نفسي على هيئة رجل حكيم. ولكن ورطتي هنا كانت أنني لا أعرف شيئًا عن الحب الافتراضي الذي كانت زميلتي تعاني حسرته.
اقرأ/ي أيضًا: الحب الرقمي
لقد تعرفَتْ إلى شاب على فيسبوك، قرأَتْ بوستاته الجريئة عن الدين والجنس والسياسة، وقرأ بوستاتها الرومانسية عن المرأة والحب وفارس الأحلام العصري. وبعد بضع محادثات على ماسينجر اقتنعت أنها تحبه وأنه يحبها.
أما أنا فكنت كمن يتفرج على واحد من أفلام الخيال العلمي، غير مصدق أنه يمكن لسهم كيوبيد أن يطير عبر أسلاك الإنترنت ليصل بين قلبي شاب وفتاة من لحم ودم.
اعتادت أن تروي صورًا عن هذا الحب المشبوب: الضحك بلا حدود حتى آخر الليل، التلقائية والعفوية، الحرية الكاملة في تبادل الآراء والأسرار، الانسجام التام الذي خلق هذا التعلق.. وبالمقابل كنت أفترض مشهدًا مختلفًا: هو يجلس بجاهزية تامة، مشذبًا ذقنه وكلماته وحركات يديه، ومقننًا ضحكاته ونكاته، وناحتًا آراءه على قوالب معدة سلفًا.. وهي على الطرف الآخر، على بعد مئات الكيلومترات، بوجه مصنوع ليلائم كاميرا تصوير.. وبين هاتين الصورتين الناطقتين أي قصة حب يمكن لها أن تكون؟!
جيلي تربى على شكل آخر للحب. حب يشاغل الحواس الخمسة وإن كان لا يشبعها، الوجه في الوجه والعين في العين، حيث يمكن ملاحظة الغمازتين الطفيفتين على جانبي الفم، وضبط الشامة التي تحاول الاختباء وراء الأذن، والتقاط رائحة العطر المسفوح من أجلنا، والتعاطف مع خصلة الشعر المشاكسة الهاربة من حفلة أناقة ليلية مضنية.. وحيث كان بإمكاننا ضبط ثرثراتنا على إيقاع روح الآخر، وقراءة أصداء ذواتنا في عينيه. أرقنا عشية اللقاء الموعود والذي يأتي أحيانًا مشوشًا ومرتبكًا بسبب هذا الأرق نفسه. رسائلنا المضحكة المرصعة بكلمات متكلفة وأشعار مسروقة، ارتجالنا لأماكن وطرق الاستلام والتسليم. الدوّار إثر النظرة الأولى، وسريان الكهرباء في أجسادنا بفعل اللمسة الأولى، والسديم البرتقالي الذي نسيح فيه عند سماعنا لكلمة الاعتراف الأولى.. "أول الحب" الذي غناه محمود درويش وعشناه نحن بيقين كامل.
أعرف أي منزلق تسير فيه هذه الكلمات: سيقال إنها حساسية جيل تجاوزه الواقع، وفقد القدرة على المواكبة فصار يلعن الزمن لأنه لا يسير على هواه، ويتنبأ بذهاب البشرية كلها إلى الهاوية لأنه بات عاجزًا عن فهم الأجيال الجديدة وطرائقها الشابة في العيش..
وكيف يميز المرء بين كونه قد صار جدًا مخرفًا عاجزًا عن التكيف، وبين كونه مجرد مراقب للحياة من حولة، يملك هواجس مقلقة يطرحها في أسئلة مشروعة؟!
يكتب جون ماكسويل كويتزي إلى صديقه بول أوستر: "إن العالم ذاهب إلى الجحيم في سلة بأذنين، كذلك كان يقول أبي، وأبوه من قبله، والآباء حتى عهد آدم. ولو أن العالم فعلًا ذاهب إلى جحيم على مدار كل تلك السنوات، أما كان ينبغي أن يكون وصل الآن؟ ولكني أتلفت حولي فلا أرى أنه يشبه الجحيم".
طيب: العالم، ومهما بدا غريبًا بالنسبة لنا، فهو لن يذهب إلى الجحيم. ولكن ألا يحق لنا، مع ذلك، أن نسأل إلى أي وجهة أخرى هو ذاهب؟!
لقد اعتدنا على الكتاب الالكتروني بديلًا عن الورقي، مكرهين على نسيان كل أشعارنا عن "رائحة الورق وملمسه وصوت قلم الرصاص المخربش على هوامشه.."، واعتدنا كذلك على الشاشة والكيبورد بدلًا من القرطاس والقلم، وكنا قد انتقلنا بسلاسة تحسب لنا من لمبة الكاز إلى لمبة النيون، ومن راديو الصندوق الخشبي إلى شاشات الفضائيات وقنوات اليوتيوب.. فهل نستطيع اعتياد الحب الافتراضي بديلًا عن الحب الواقعي؟
لا خوف على غريزة البقاء فإن لها طرقها للبقاء، ولكن ماذا عن الحب ذاته ولذاته؟ هل سيبقى حبًا وهو يصنع عبر كاميرات وأسلاك وشاشات؟ هل سيظل المسكّن الأعظم لقلق الحياة، العزاء الجميل الذي رافقنا كل هذه الآلاف من السنين، نبع الماء البارد والعذب في صحراء وجودنا؟
تقول صديقتي العشرينية: أتمتة الحب وانسحاق الإنسان أمام التكنولوجيا؟! تتحدث وكأننا في أوروبا أو أمريكا. لا نزال بعيدين جدًا عن ذلك. ثم أننا نلجأ إلى العالم الافتراضي هربًا من عالمكم الواقعي الذي أورثتمونا إياه. في أي حدائق نستطيع الجلوس وجهًا لوجه؟ في أي شوارع نمشي يدًا بيد؟ أين هي الأنهار لنتمشى على ضفافها؟ كيف لنا أن نقابل ونغازل في أمكنة تعيش تحت رحمة كل هذه البنادق المستنفرة؟ كيف لنا أن نُحِب ونُحَب في هذا الواقع المليء بالعفن؟!
لا خوف على غريزة البقاء فإن لها طرقها للبقاء، ولكن ماذا عن الحب ذاته ولذاته؟ هل سيبقى حبًا وهو يصنع عبر كاميرات وأسلاك وشاشات؟
لها، إذًا، أن تتابع بحثها عن قصة حب افتراضية جديدة، ولنا نحن أن نستمر في لعن الواقع.. الواقعي والافتراضي معًا.
اقرأ/ي أيضًا: "وصفوا لي الحب".. أيديولوجية العاطفة في القرن الـ21
يرد بول أوستر، في رسالة جوابية: "بوصفنا رجلين محترمين يشيخان بسرعة، ومراقبين معتقين للكوميديا الإنسانية، وبرأسين شائبين رأيا كل شيء ولا يندهشان من شيء، أعتقد أن من واجبنا أن نتذمر ونقرِّع.. علينا أن نستمر ونحن نتحرى أقصى درجات الحذر، نبيين متذمرين يصيحان في البرية، لأننا نعلم علم اليقين أننا نخوض معركة خاسرة، لكن ذلك لا يعني أن نتخلى عن القتال".
اقرأ/ي أيضًا: