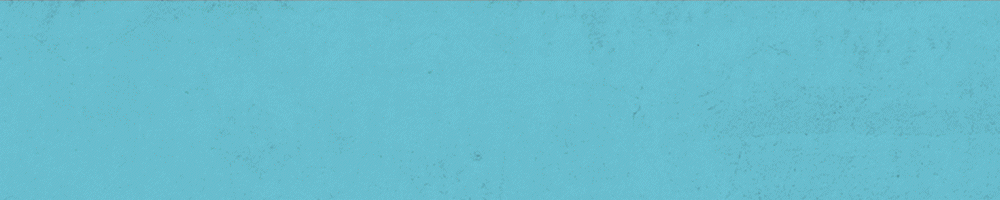في ثلاثينات القرن العاشر الميلادي تناهى إلى الخليفة العبّاسي، الراضي بالله (حكَم 322-329هـ) أنّ جماعة من مشبّهة الحنابلة أفشَوْا في أرجاء بغداد أحاديثَ منكَرة في حقّ الله تعالى نسبوا له فيها الجوارح والسير بين الأفلاك وغيره ممّا يقشعِرّ له بدن المؤمن المعتاد. ثمّ إنّهم استبدّوا بالمساجِد وأوغروا فيها العنف الطائفي؛ وأشلَوْا مكافيف الجوامِع على الشوافِع. فبعث إليهم الخليفة بتوقيع شديد اللهجة أوردَه ابن الاثير في حوادِث 323هـ جاء فيه:
"تزعمون أن صورة وُجوهِكُم القبيحة السّمجة على مثالِ ربّ العالمين وهيئتكم الرذلَة على هيئته! وتذكُرون الكفّ والأصابع والرجلَيْن؛ والنّعْليْن المذَهّبيْن؛ والشَّعْرَ القَطِط؛ والصعود إلى السماء؛ والنزول إلى الدنيا! تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً. ثمّ طعنكم على خِيار الأئمة ونسبتكم شيعة محمدﷺ إلى الكفر والضلال؛ ثم استدعاؤكم المسلمين إلى الدين بالبدع الظاهرة والمذاهب الفاجرة التي لا يشهد بها القرآن؛ وإنكاركم زيارة قبور الأئمة وتشنيعكم على زوّارها بالابتداع؛ وأنتم مع ذلك تجتمعون على زيارة رجلٍ من العوام، ليس بذي شرفٍ ولا نسبٍ ولا سببٍ برسول الله ﷺ؛ وتأمرون بزيارته؛ وتدّعون له معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء! فلعن الله شيطاناً زيّن لكم هذه المنكرات. وما أغواه! وأميرُ المؤمنين يقسِم بالله قسماً جهداً إليه، يلزم الوفاء به، لئن لم تَنْتَهوا عن مذموم مذهبكم ومعوَجِّ طريقتِكم ليوسِعنّكُم ضرباً وتشريداً وقتلاً وتبديداً وليستعمِلّنَ السيف في رقابِكُم والنّار في منازلِكم ومَحّالِّكم".
إنّ علم الكلام الذي لعب، إلى جانب السياسات المعرفية للدولة العبّاسية، دوراً كبيراً في تضعيف هذه المقولات التجسيميّة سرعان ما اضمحَلّ بعد أن أدّى مهمته التاريخية وحلّ محلّه إيمان العجائز. ولكن هذا "العِلم" عاد مؤخّراً للتفكير الإسلامي على مستويَيْن: فكري: يلتحق بعودة الثيولوجيا وهو ما عمّمه متكلّمون كستانلي هَاوَرْواسْ ودافيد بلانتينغا وطه عبد الرحمن ومَرْسي أمبا أودويُويْ إلخ، ناهيك عن التكلّم المتزايد في اللاهوت. وله مستوىً شعبي يتمثّل في عودة الكلام إلى الاستهلاك اليومي. ولهذا بدوره أسباب منها ظهور ما اصطُلِحَ عليه بـ"الإلحاد الجديد" الذي طرق الأبواب المحلية مع الربيع العربي. بل سبقه: لأنّ أحد متكلّمة الغرب وهو ويليام كريغ قد استدخل الأدلّة الإسلامية في ردّ الإلحاد الغربي. فخرج من القُمقم متكلّمة الإسلام، الذين كانوا قد انزوَوْا في مكان قصي عن التفكير العمومي حافظوا فيه على جذوة نقاشاتهم في صراعات الفِرَق والذبّ عن المذهب. كان الكلام في صدر القرن العشرين أشبه بحروب السحرة الذين يتراشقون بالتعاويذ التي لا يفهمها غيرهم. ولكن مع فشل الوعظ استُدعِي السَحَرة وعاد الكلام للعب دوره الوظيفي في تاريخ الإسلام.
ولكنّ المشكلة أنّ الكلام بدل أن يأتِيَ بالتسديد جاء بالشقاق. وقيل إنّ هذه مشكلة بنيوية. فالكلام الإسلامي، كما ذهب بيتر كريفت، افتقد الوسطية. فالأشعري فرّق العقيدة والفلسفة؛ وابن رُشد صحّح العقيدة بالفلسفة. وهكذا برأيِه غاب من الإسلام مفكّر وسطي كالأكويني يُصحّح الفلسفة بالعقيدة: فصار الإسلام قائماً على حروب صفرية بين الإيمان والعقيدة. وطبعاً ليس علينا تصديق كريفت. ولكن عودة الكلام الحالية بدل أن تحمي الدّين من الإلحاد أتاحَت فِعلاً حرباً بين المؤمنين على الوسائط الشعبية (بالتوك ثمّ كلوبهاوس ويوتيوب). فمن ناحية رفض الأصوليون استدلالات الكلام؛ واعتبَروا أنّ الإله الذي يُثبتُه علم الكلام ليس إله المسلمين، بل هو إله الفلاسفة، الذي يصدُر عنه العالَم بالضرورة لا بإرادة تعلو عليها. أمّا إله الأحاديث فلا يُثبَتُ بالنظر إذ يضعه النظر في متتاليات هو خالِقُها. وعليه فإنّ الله- برأيِهم- لا يُعلَم بالمنطِق، بل بالسمع. ومن ناحية أخرى ذهب متكلمة الأشاعِرة كسعيد فودة ومؤخّراً مولود السريري، ومعهم بعض الحنابلة الجُدد، أنّ المُثبِتة، وإن تحوّلوا من التشبيه الذي هاجمه الراضي بالله، إلى التفويض والتوحيد المجرّد مازالوا يخفقون في التنزيه لأنّ "التفويض في المعنى لا يرفَعُ الكيف" ولأنّهم يقولون بالحدّ الأدنى بين الصفات والأجسام. فإمّا نفي الحد الأدنى أو التشبيه. وبعبارة أخرى فإنّ الكلام الجديد بدل أن يُسدّد الدّين فإنّه تحوّل إلى مفاصلة بين الفِرَق والطوائف.
لماذا هذا العَوْد الأبدي للجدالات الكلامية؟ ولماذا يصعب على صفوة المسلمين تجاوز التشبيه والتنزيه؟ والجواب أنّها ليست بمجرّد جدالات في الذات العلية بل تُلَملِمُ كذلك ثنائيات الثقافة في الحرف والمجاز؛ والظاهر والباطن؛ بل والدّين والدولة؛ والتقليد والاجتهاد. فهي إذاً نقاشات حِزبية إسلامية تقابل طريقتين في التعامُل مع المتعالي: طريقة الفلاسفة في تجريده؛ وطريقة المؤمنين في الإحساس به. وكان محيي الدّين بن عرَبي (1165-1240م) قد أدرَك هذا عندما اقترَح أنّ نقاش التنزيه والتشبيه هو في حقيقة الأمر نقاش المفارقة والمحايثة. المفارقة هي السمو؛ والمحايثة هي الدنو. فمقام التنزيه أنّ الله خارِج العالَم؛ ومقام التقريب أنّ علاقته به علاقة التجلي. فبقدر ما الله متعالٍ عن الكون فإنّه يُدرَك في هذا الكون وبقوالِبه، فلا بدّ أن يحصُل من التمثيل، وليس التشبيه، ما تصير به عبادة الجسد. أمّا عبادة العقل فمقامها التجريد والتنزيه، وهي أولى مقتضيات العقل والتسبيح.

يستخدِم ابن عربي لهذا عبارة "التجلّي"، التي أسيء فهمها كثيراً. فلتجلي الله من المخبوئية إلى الظاهرية مرتبتان: أنطولوجية وابستمولوجية. ويستعين ابن عربي بالأسماء الحُسنى فهي تظُهر التجلي الوجودي في اسم "الظاهِر" والتجلي المعرفي في معنى "الباطن". فالله من حيث كنهِه وجوهره غير قابِل للمعرفة ومقام ذلك المفارقة (transcendence). أمّا التجلّي الوجودي فهو ما تحصُل به علاقة الكون بالإله ومقامه المحايثة (immanence). ويربط ابن عربي هذا بثنائيتين: الجلال والجمال. فبالجمال تتجلّى أسماء الله في الوجود وقوالب الكون؛ وبالجلال يسمو الله على هذه القوالِب. وبعبارة أخرى فلا بد من تمييز الله من جهته هو؛ والله من جهتنا نحن. فمن جهته وكنهِه يحصل المبهم والاستحالة المعرفية؛ ومن جهتنا، جهة الفتوحات الربّانية والدين، يحصل التحقّق. وإذا استأنسنا بعبارات هيغيلة سارترية، فلا بدّ أن نميّز في الله بين ما هو لذاتِه (en soi) وما هو لغيره (pour soi)
فإذا فُهم هذا فُهمت عبارة دارس ابن عربي الكبير، ويليام تشيتيك، أنّ "ابن عربي هو ذروة الفِكر المُسلِم". إنّه هيغل الإسلام. فهو يُظهِر تعالق الأفكار بدل تصارمها. بل إنّ تناقُضها الظاهر يخفي نسقيتها الباطنة. فلاهوت التنزيه هو مقتضى العقل. ولكن الإيمان الحقيقي يقتضي استقدام المخيلة والعمل، لا مجرّد التجريد. والحقّ أنّ تواريخ الكلام وصلت لهذه الترتيبة بطرق متفاوتة. لقد حلّ متأخّرو المعتزِلة مسألة الأسماء والصفات بصرفِها إلى مجال اللغة؛ ومن هنا اكتشَفت البهشامية- من خلال أبو هاشم الجُبّائي (275هـ/888م-321هـ/933م) القاضي عبد الجبّار (359 – 415هـ، 969 – 1025م) نظرية الأحوال: فتغيّرات المتعالي إنّما هي من جهتنا، من جهة اللغة، لا من جهة كنهه الأزلي والثابت. أمّا حلّ ابن عربي فهيغلي الطابِع. ذلك أنّ هيغل ارتأى أن يُعطِي صورة ترتبِط فيها المحايثة بالمفارقة في عملية تلاحمية تنتهي بإدراك المطلَق لذاته في تصالح وتلاؤم الأضداد. حاول المعتزلة هذا بإدراك بإله عادل لا يتدخّل في الكون، بل الكون امتحان عادل منه لإرادة البشر الحُرّة. ولكنّهم- وبالأخصّ من سُموا بمتصوّفتهم كالجعفران والإسكافي- سرعان ما انتبهوا للوجه الجمالي وليس فقط الجلالي للمتعالي؛ فأدخل البغداديون منهم فكرة الأصلح والألطاف. إنّ الألطاف هي محايثة الاعتزال. وهو نفس ما فعله لايبنيتز في مسألة العوالم، والأصلح: فبالذات لأن الله جميل وخيّر فيتعيّن عليه الأصلح للناس. وكان الأصلَح عند غالب المعتزلة في الدين لا الدنيا؛ ولكن الغزالي ولايبنيتز استدخلاه في الكوسمولوجيا إذ "ليس في الإمكان أبدَع ممّا كان". وذهب لايبنيتز إلى أنّ الأصلح هو ما يتمّ به أفضل العوالم بالحدّ الأدنى من القوانين: وهي فكرة البساطة الميتافيزيقية، التي هي مبدأ معتزلي يؤسّس اللاهوت السلبي، المسمّى لدى خصومهم بالتعطيل. فحتى هؤلاء لا يستعيضون عن مستوى من المحايثة. ولكن المحايثة ليست تشبيهاً طبعاً.
يمكن لابن عربي أن يُساعدنا في معضلتنا الفكرية المعاصِرة بلملمة الاختلافات الكلامية في نظرية في المطلق. ومنذ فترة أدرِكت أهميّة هذا في تاريخ الأفكار المعاصِرة. فكانط تخلّص من المفارقة بنفي استحالة معرفة الشيء في ذاته وهكذا سجن المفارقة في الإيمان بها. إنّ ابن عربي فعل هذا فنحن لا نعرف المفارقة خارج التجلّي. ولكن مفارقته ليست مسجونة في الصدور، بل في الظاهرية، أي تجلّي المفارقة في تجارب العارفين ومدارج السالكين. إنّ ابن عربي يُصلِح الكانطية بالظاهراتية والوجدانية (Affect). ثمّ إنّه يُساعِد في نقل الأفكار من المٌسكِرات الكلامية إلى فلسفة متعالية. فهو- كما فعل هيغل- يُصلِح شقاق المادية والمثالية بإدخالها في قانون جدلي. إنّ إصلاح الماديّة، منذ غاستون باشلار حتى كارين باراد، بإدخالها في المُطلَق هو مشروع راهن. فباشلار جدّد الماديّة بإدخال الوجدان فيها فهي ليست مادة خاماً بل علاقات روحية كذلك.
يمكن لابن عربي أن يساعِدنا كذلك في الترجمات الثقافية. فلو سألنا المعاصِرين عن مقابل الشيطان لشخصوا إلى الله. إذ مع العصر الحديث صعَد لاهوت التشبيه وتُرجِم الشيطان، كما في الفردوس المفقود لميلتون، أنّه خصيم الله في ملحمة أنطولوجية. وسرعان ما عاد بنا هذا اللاهوت التشبيهي والحداثي إلى الثنوية، التي قهرها الكلام المعتزلي عند ابراهيم النظّام ومعمّر بن عبّاد. ولكن مقابل الله في أنطولوجيا ابن عربي ليس الشيطان، إذ لا يمكن إدراك الله. وإنّما يُناقِض الشيطان أسماء الله. ويورِد في ذلك ثنائية الشيطانية والرحمانية. وكما بيّن ابن سينا فالشرّ ليس من بنية العالَم المفارق، بل من بنية الدنيا.
إنّ حلّ ابن عربي لمسألة المفارقة والمحايثة راهن في الثقافة الإسلامية. بل والغربية: فالثورة التي قادها دولوز ضدّ هيغل وألغى بموجبها المفارقة واستبدلها بالمحايثة، سرعان ما تبيّنت محدوديتها. وصحيحٌ أنّ البنية الجذمورية (Rhizome) لتفكير دولوز من خلال ميتافيزيقا الاختلاف متضَمّنة في ابن عربي (بل إنّ الاستخدامات الفكرية الذائعة لابن عربي منذ نصر حامد أبو زيد هي أنه فيلسوف الاختلاف) تماماً كما أنّ دولوز متضّمن أصلاً في هيغل، كما بيّن سلافويْ جيجيك. إلاّ أنّ ذلك لا يكون إلاّ باستعادة المفارقة في نسق الاختلاف.
خلاصة: هذه مقالة سريعة كُتبت في تسديد المنعرج الكلامي في الثقافة المعاصِرة. فلهذا أن يستبدِل المنعرج الوعظي الذي ميّع الإسلام المعاصر وسطّح المفاهيم؛ وله أن يُسند الإيمان عقلياً ويبلور ثقافة قائمة على الاستدلال والنقد، لا التكرار والترديد. ولكن هذا المنعرج يأتي بوعود أخرى منها إعادة ثنائيات التشبيه والتنزيه واستقدام مراجيح ومخاريق المتكلمة. والأحسَن لملمة هذه الثنائيات بتفكير مثالي متعالٍ (speculative) ومادي مُحدَث. تاريخياً قام بهذا كلٌّ من ابن عربي وهيغل وباشلار. وما زالت الإمكانيات الفكرية لهذا راهنة. وبعبارة أخرى يجب أن ينصِرف علم الكلام الجديد ليس إلى الميتافيزيقا القديمة والصراعات الفِرقية حول الأسماء والصفات، بل وإلى إعادة تدوير الميتافيزيقا فلسفياً وترتيب فلسفة في المسألة الدّينية. عندها سيقال بالفعل أّنّ الكلام، لا شطح الكلام، قد رجَع.