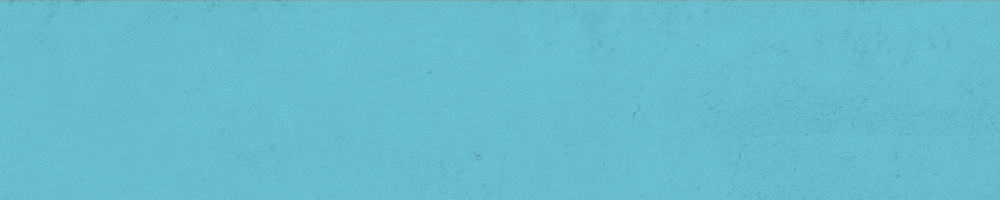لم أتجاوز الخامسة عشرة حين كنتُ في عزّ الظهيرة أسقي الزّرع حافي القدمين، آملًا أن تتشقّق الكِعاب من الماء الكلسية لأصبح أَرْجَل. كنتُ أُعلّق السيجارة في زاوية شفتيّ بينما أغرز الرّفش الأطول من قامتي في التراب، لأدعّم بالقليل منه عمود الفلاحة الذي تكاد أن تطوف من على جانبيه المياه.
لم أجرؤ على حمل السجائر معي كي لا يكتشف أهلي الأمر، فأُخفي علب الدّخان في أماكن مختلفة، في البيت وعلى أطراف القرية وفي البساتين، لأمجّ منها ما أشاء بعيدًا عن العيون والأنوف.
أنا من الذين دخّنوا الحمراء الطويلة كثيرًا، وفي سنوات الجامعة والحرب صرتُ أدّخن الحمراء القصيرة الورق
في ذلك الصيف، اعتدت أن أخبّئ "باكيت الشرق" بين الأغصان الكثيفة المتفرعة من أسفل جذع آخر شجرة في حبل الرمّان المحاذي لصفّ السرو العملاق، حيث احتمالات العبور من هناك ضئيلةٌ أكثر.
كم ندمتُ لأنيّ عندما كنتُ مستعجلًا فأطفأت "موتور الليستر" وركضتُ لأحتفظ بالسجائر داخل بقعة القصب عند سفح تلّة الكلس المتكومة قرب البئر، لأعود إليها صباح اليوم التالي بعد أن شربت أوّل كأس متة مُعدّةٍ على الحطب، لأجد أنّ أبي قد سقى القصب فغمرت المياه سجائري وتركتها مفتّتة، فاضطررت لجمعها وطمرها كي لا يراها أحد.
وهكذا تعلّمتُ التدخين في الحقول، كنتُ أستلقي في أعماق الحنطة أنظر إلى السماء والماء يجري ثمّ يدلف إلى المسكبة، ثمّ أرمي العقب في الساقية قبل أن أحجزه عنها لتمضي باتجاه المسكبة التي تليها.
بعد انتهاء أيام عزاء جدي، أدخلت السجائر التي أطلت بفلاترها من فتحات العلب الموزّعة على الطاولات الصغيرة في بيت الشَّعر إلى مكانها. لقد خُصّصتْ ليسحب منها المعزون ويستلذوا بالتدخين مع القهوة المرة. ثمّ جمعتُها في كيسٍ تناوله مني والدي ووضعه في أحد أدراج مكتبه. ظلّلت لأسابيع أختلس منها حتّى أحسّ بأنها تفرغ فأسعدَ بها أحد أعتى المدخنين في القرية.
صديقُ الدخان هو حافظ السرّ وصفوة الأصحاب. كنّا نركب الدرّاجات النارية ونقطع الكيلمومترات باتجاه البساتين من أجل أن نُدخّن. ثمّ قبل العودة إلى البيت نلوك عِرق نعنع أو زعتر أخضر كي لا تشمّ رائحتنا الأمهات فتشي بنا إلى الآباء.
الله يرحمك يا ستي، لو تدرين كم حشرت علب الدخان بين طيّات الفرشات، تلك التي لا نستعملهن إلا حينما يأتي بيت عمي من حمص، أو لينام عليها الضيوف الذين يُسافرون إلينا لتقديم واجب العزاء عندما يموت عجوز من العائلة.
مرّةً استغرقتُ أكثر من ساعة في المشوار الليلي على الأقدام، حتى وجدت علبة دخّان فيها ثلاث سيجارات وضعتها تحت حجر، ونسيت في أيّ كومة من تلك التي كانت على جانبي الطريق شرقيّ القرية.
دخّنت مع رفاقي في المقابر ووراء المدرسة وفي حمّاماتها، ليُنقش اسمي بالوقت نفسه في موضعين في لوحة الإعلانات المعلقة قرب غرفة الإدارة، على أحد أغصان شجرة المتفوقين وفي قائمة المفصولين لمدّة يومين بسبب التدخين داخل حرم المدرسة.
أنا من الذين دخّنوا الحمراء الطويلة كثيرًا، وفي سنوات الجامعة والحرب صرتُ أدّخن الحمراء القصيرة الورق، وفي ذروتها تعلّمت لفّ التتن لأغبّ العربي لسنوات. وعندما علا صوت سعالي قرّرت أن أدخّن تبغًا أجنبيًّا مع بضع ذخائر حمراءَ طويلة لتعبئة الرأس في السهرات مع الأصدقاء.
حزنتُ من قلبي لمّا رأيت أبي مبتهجًا لأنه صدّق أنني توقفت عن التدخين، حصل ذلك عندما لم يعد يراني أخرج من غرفتي وأختفي. لم يكن يعرف أنني في الأيّام التي لا تهبّ فيها رياحٌ قويةٌ في الخارج تعلّمتُ فتح باب المدفأة كي أنفخ الدّخان داخلها فتسحبَه دون أن يتصاعد خيطٌ واحدٌ داخل الغرفة، ثم أرمي الفلتر في النّار الزرقاء وأُكمل قراءة رواية أظلّ متأهبًا لدفنها تحت الكتب المدرسية إنْ دخل عليّ أحد. هكذا حتى عُدت مساءً إلى البيت لأتفاجأ أنّ أبي يستضيف على غير العادة أصدقاءه في غرفتي، حين لم يردّ عليّ السلام ورمقني بنظرة تقول "يا كلب"، علمتُ أنّ المدفأة لم تشتعل كما يجب فنظر داخلها من الأعلى ورأى مخلّفاتِ الأعقاب المتفحّمة.
اليوم، آمل أن يكون راضيًا لأنني حقّقتُ رغبته وتوقّفتُ عن التدخين منذ أكثر من خمس سنوات، ولعليّ أستمرّ في استنشاق الهواءِ النقيّ وتخبئة الحنين في مكان ما.