بُعيد أيام من عيد الحب، تقول طُرفة: "سأجلس يوم الفالنتاين بأحد مقاهي العشاق، وأحمل هاتفي، متظاهرًا بأنني أتكلم عبره. وأقول بصوت مسموع: تعال شوف أختك مع من هي جالسة!".
الحب في تطبيقات المواعدة الإلكترونية يتمثل شعار الجيش الأمريكي: "حرب بصفر قتلى"، إذ يفتقد حيوية الحب وعفويته
يحمل هذا النص الساخر في قلبه كثيرًا من المفاهيم، وبشكل أكثر سخرية يحدد تصورًا واضحًا عن الحب، في تقلبه بين مستويات ثلاثة: الأخلاقي، والفلسفي والاجتماعي. حيث يفصح من خلال مستواه الأول عن التركيبة الأخلاقية التي تحكم هذه الفعالية الإنسانية، في شكلها العنيف، يبرز الجسد الإجتماعي مطاردًا، ممتلكًا بين الثنائية الجنسانية المتصارعة، وبين ثلاث سيادات أساسية، هي في الأصل ذكر واحد يتنازع انفصامه: المحب، الأب والرقيب الأخلاقي.
اقرأ/ي أيضًا: حتمية الحب التعيس.. العيب ليس فيكم ولا في حبايبكم!
على مستوى ثانٍ، في تقلب النص بين العنف والمتعة، ترتسم دائرة من القلق يتموقع وسطها الحب، فكرة مجردة، هذا الحدث المضطرب في ذاته، والمضطرب في موضوعه، بين نظرتين: نظرة العشاق المضمرة، ونظرة الواشي المعلنة والمهيمنة، وعليه بين تمثلين: الأول أفلاطوني، منطلق من الخاص إلى العام، من المحدد إلى المطلق. والآخر معاكس، أي من فكرة الحب المجرد إلى حب الجسد، وبشكل أكثر تدقيقًا، حب تفصيل محدد من الجسد.
وفي مستوى ثالث من النص، المفترض كونه فكاهيًا، يتبدى الوعاء الحامل لكل ما يود إخبارنا به، أو بتعبير آخر الزمكان: مقهى عشاق يوم الفالنتاين. بما هي رمزية تنفلت من حدود النص وتتعداه، إلى ضرورة تاريخية محددة مسبقا بقاعدة مادية، ينبني عليها الفعل حصرًا، ولا يخرج عنها وعن الممارسة المؤسسة له مسبقًا والمطبع معها.
الأمان.. أو التحكم بسوق الحب
نهاية العقد الأول من الألفية الثالثة، حيث كان العالم الافتراضي لا يزال على طراوته البدائية، واللوغاريتمات لا زالت بشكلها الطفولي عكس ما هي عليه الآن في فيسبوك مثلًا؛ اعتلت جدران باريس حملة إعلانية لموقع ميتيك للمواعدات الغرامية. في "مدح الحب"، ينطلق المفكر الفرنسي آلان باديو من تفكيكه لشعارات هذه حملة، ليقدم نقده للغراميات في تصورها المعاصر.
"احصل على الحب دون انتظار الصدفة"، يقول شعار الموقع المذكور، ويقول أيضًا: "يمكن أن نحب دون الوقوع في الحب!". وهكذا يتبدى المقصود كله، أي ذلك الرعب المرضي من المعاناة، والبحث المرضي كذلك عن النشوة. لكن السؤال المطروح هنا من باديو، هو: ما هي منطلقات هذه الوصاية الإلكترونية على تجربة الحب؟ مشبهًا هذا الشعار بشعار آخر للجيش الأمريكي هو: "حرب بصفر قتلى".
هل يمكن تخيل حرب كهذه؟! في المقابل، فمحاولة الانفلات من قبضة الاستعارة اللغوية البراقة، تجسد واقع التسيّد العرقي والوطني داخل النص، حين يخرج من صيغته المعلنة إلى المضمرة وغير المنطوقة، أي أن الحرب بصفر قتلى من الجانب الأمريكي فقط. لكن ماذا عن الجانب الآخر؟
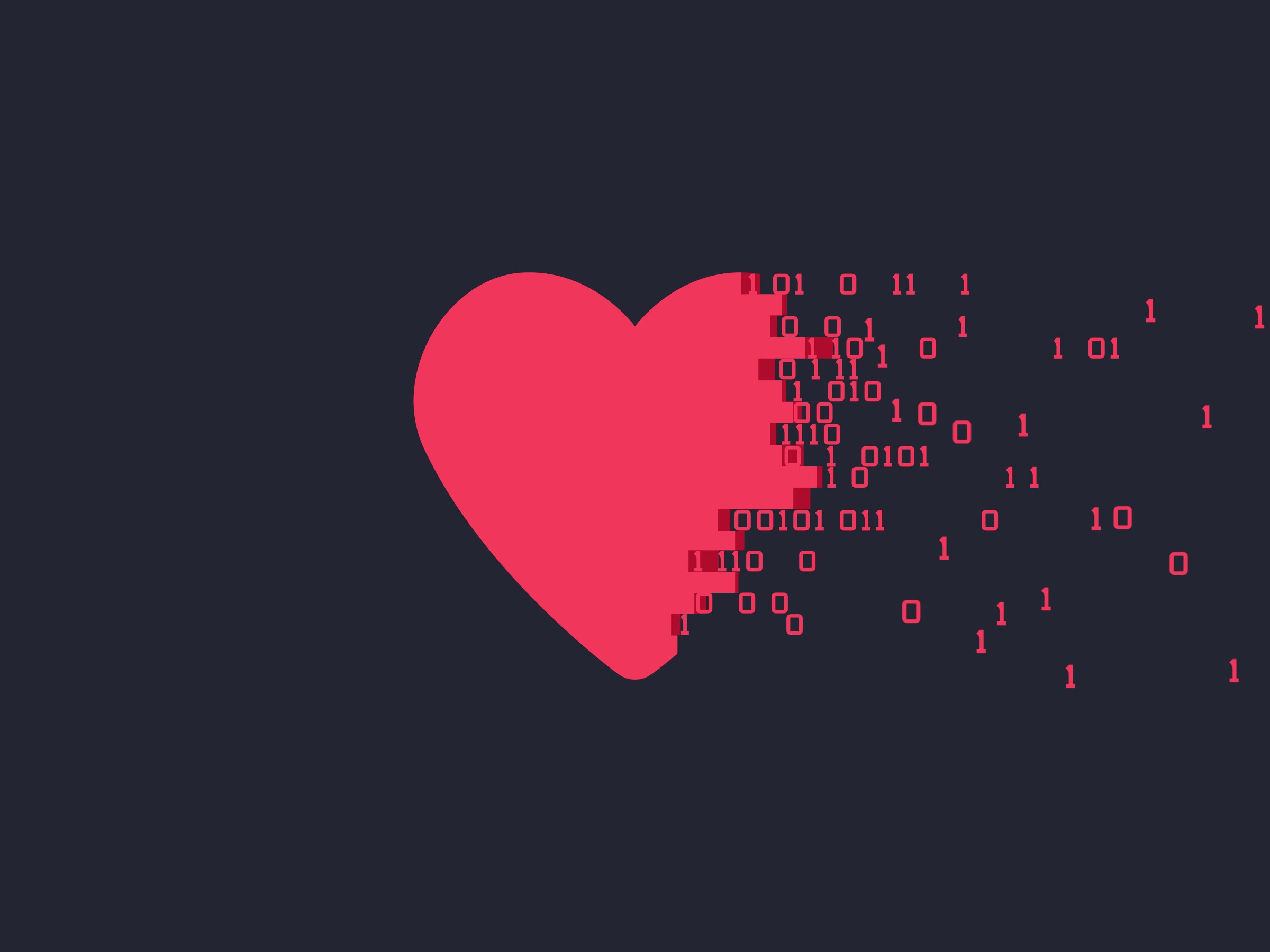
يحيل هذا إلى إشارة مضمرة إلى أنه على الجانب الآخر إنسان لا يستحق الحياة، وقابل للقتل والإبادة من قبل السيد الذي سيخرج من الحرب بصفر قتلى، وأن هذا هو المهم!
هكذا قد يتضح أن الفكرة واحدة: حرب بصفر قتلى، وحب بصفر مخاطرة. فالحب في هذه الجهة مرتب ومتحكَم فيه بدقة، منتزع من صفته الحيوية، أي العفوية، ومدروس بشكل قد تنعدم فيه الصدفة والمخاطرة الجامحة، وبتعبير أكثر تقنية، فأنت في هذا الحب لا تلتقي إلا الشخص المناسب لك، حسب عمليات الانتقاء الإلكترونية، التي تدرس في غفلة منكما كل تفاصيلكما الحياتية، والأكثر حميمية منها.
ومن ناحية أخرى يقوم هذا التصور على إنكار أهمية واقعية الحب، وإحالته إلى واقع نافل وتنويعي، لعملية استهلاك المتعة الجسدية. وهو استهلاك يحافظ على قواعده التسويقية بطبيعة الحال.
الصوابية.. أو الحب كتعاقد بيروقراطي
"أنت جميلة، لكن، لو أنقصت وزنك قليلا ستكونين أجمل!" تحدد عبارة كهذه الرغبة، وبشكل عكسي لصيغتها الأفلاطونية، فإنها تنطلق من العام إلى الخاص، ومن مفهوم الجمال إلى التفصيل الجسدي.
جيجك: "الجنس يخضع لوطأة ألعاب السلطة، والفواحش العنيفة وغيرها، لكن ما يصعب الاعتراف به أن هذه الأشياء متأصلة فيه"
يقول المفكر السيلوفيني، سلافوي جيجك: "أعتقد أن الاصطلاح الانجليزي: تحبيب العيوب (endearing foibles)، هو مكون أساسي في خلطة الحب، بحيث لا يمكنك أن تسقط في غرام شخص مثالي"، منتقدا بذلك الاستثارة الأخلاقية التي يحدثها وقع كلمات كهذه، أو بلغة حماية هذا الكمال المتخيل بممارسة صوابية سياسية في المقابل.
اقرأ/ي أيضًا: صادق جلال العظم.. تفكيك الحب
وينطلق جيجيك في ذلك من سنده اللاكاني في التحليل النفسي، والقائل بأن سقوطك في الحب علامة على عدم الكمال. بل إن الحب، حسب نفس النظرية، هو حب للنقص بما هو إرادة قوة متجسدة في العلاقة: "أنا أحبك رغم نقائصك". وفي ذات الوقت تعريف للحب كفعل لا أخلاقي.
هكذا ينصب جهد النقد لدى سلافوي على مفهوم "المواعدة الإلكترونية" كشكل من أشكال وصل روابط الحب، أي في البحث الدائم للطرفين عن تحقيق الكمال المثالي.
وهذا البحث عن الكمال، أو عدم الاعتراف بالنقص، الكامن في الممارسات الغرامية بشكلها التعاقدي، والمؤطر لهذه العلاقة، من لحظات الإغواء الأولى إلى تحصيل الشبق؛ تجد التعبير الأمثل لها في الصوابية السياسية التي عادت تحكمها، والتي لا تقل قهرًا عن العنف المادي الممكن نشوبه داخل العلاقة.
أيديولوجية العصر التي تنتزع العفوية من تجربة الحب، وتضع العقد القهري قبل العلاقة، تُنصب نفسها في حماية طرف عن الآخر، وهو هنا عادة الذكر المتسيد، بينما يكون الطرف المفترض ضعيفًا، لاعب كذلك داخل لعبة الحب غير البريئة، محمياً بقولة "نعم الواعية والطوعية"، والتي تبدو لوهلة بسيطة النطق من الطرفين.
يكتب سلافوي جيجك: "تخيلوا، بعد الحصول على قبول المرأة، عندما يكون الحبيبان المحتملان عاريان على الفراش، تعطل تفصيلة جسدية صغيرة (لنقل صوت التجشؤ الثقيل غير المحبب) السحر الحميمي وتجعل الرجل ينسحب؟ ألا يعتبر ذلك إذلالًا كبيرًا للمرأة؟".

ولنتابع دعوة التخيل تلك، حيث الرغبة لا تكون عادة محددة مسبقًا بتفاصيل مدروسة، تتحول إلى مفاوضة مفصلة من "نعم لكذا، ولا لكذا"، كلما زادت تفصيلًا يصير الحوار في مجمله اتفاقًا بيروقراطيًا مطوّلًا.
يخلص جيجك، إلى أنه "نعم، الجنس يخضع لوطأة ألعاب السلطة، والفواحش العنيفة... إلخ، ولكن الشيء الذي يصعب الاعتراف به، هو أن هذه الأشياء متأصلة فيه".
البنية.. أو صناعة الحميمية
"لا يحدث الصراع بين القديم والجديد بين الطبقات فقط، بل في داخل كل فرد، وهذا ما نشهده في هذه المعركة لدى الرفيق. إنه يعرف، لكن عواطفه تسحبه إلى الخلف"، في هذا المقطع من رواية "إدوارد والله" لميلان كونديرا، ما يشير إلى الطابع المتناقض لفعل الحب، بين الداخل والخارج، والذات والموضوع.
الحب كعاطفة قد يكون علة مثالية، غير أن الإنسان بما أنه جزء من واقعه، فإن هذه العاطفة تنبت من صراع الطبيعتين فيه: أي المادة والمثالية، وهكذا تتركب كل تفاعلات الحميمية عند الإنسان.
انطلاقًا من هذا يدرس ميشيل فوكو تمرحل الحب، في كتابه "تاريخ الجنسانية"، إذ يحيل إلى أن الجنسانية ممارسة دائمًا كانت محددة ببنية سلطوية تحكمها مسبقًا، وتجعل منها حلبة لتمديد جذورها وتحكمها بالواقع، من الحقبة الفيودالية حيث كان الفرد امتدادًا لجسد الملك، وبالتالي امتدادًا لجسد الرب، إلى الحقبة الأولى من العهد الحديث الذي نقل الممارسة إلى شكلها الجديد، الوظيفي داخل نمط الإنتاج، أي وحدة الأسرة بتصورها المحافظ.
الحب كعاطفة قد يكون علة مثالية، لكن الإنسان بما أنه جزء من واقعه، فإن هذه العاطفة تنبت من صراع الطبيعتين فيه: أي المادة والمثالية
وتحصل بذات الكيفية نفس العملية الآن، ليس ممارسة للحب بتحرر، وإنما ضبط لإيقاه ممارسته مع ساعة العصر الحالي، في تجلٍ للفردانية داخل مجتمعات العولمة.
اقرأ/ي أيضًا:
